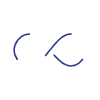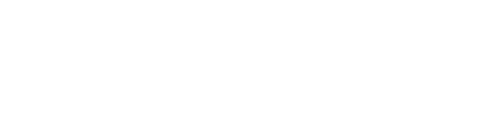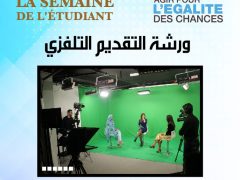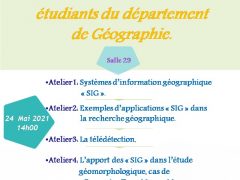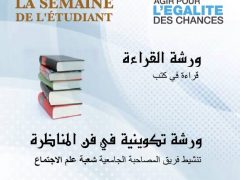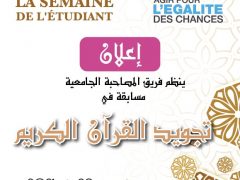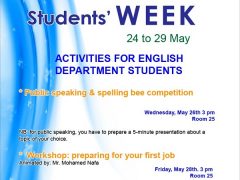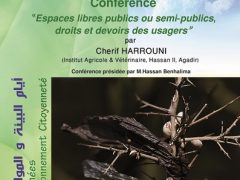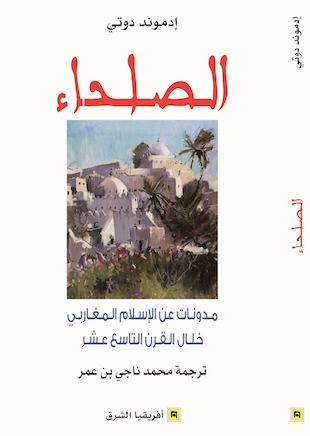
الصلحاء : مدونات عن الإسلام المغاربي خلال القرن التاسع عشر
للدكتور محمد ناجي بن عمر تجربة متميزة في ترجمة كُتب ذات طابع إثنوغرافي وأنثربولوجي ما انفكت تحظى باهتمام الباحثين المهتمين بإعادة قراء تاريخ مغرب القرن التاسع عشر، لعل من أهمها ترجمته لـ “زمن المحْلات السلطانية”[1] وترجمته لأحد هم أسفار دوتي على الإطلاق وأعني به كتاب “مراكش أو قبائل الشاوية ودكالة الرحامنة سنتي: 1901-1902 “[2]. ومعلوم أن لأدموند دوتي كتب أخرى لعل أهمها تقاطعا مع كتاب “الصلحاء” كتاب “السحر والدين في أفريقيا الشمالية”[3] وكتاب “مهمة في المغرب: بين القبائل” (1914).
وربما كان أكثر ما يلفت نظر الباحث في تراث هذا البحاثة هو قدرته العجيبة على تحليل ومقارنة وغربلة ركام من الأخبار/الحكايات/النوادر.. التي يقوم بجمعها بهدف قراءة واستخلاص نتائج انثربولوجية، وسوسيولوجية في فهم جوانب من المخيال الجمعي المغربي في لحظات وأزمنة محددة وفي أماكن جغرافية متنوعة (مناطق واسعة/قبائل/ سهول ..إلخ.).
وعلى الرغم من القيمة المعرفية والعلمية لإنتاج إدموند دوتي إلا أن غالبية المترجمين والدارسين له لا يكادون، على العموم، يستثنون كتاباته من مجمل الكتابات التي سعت إلى التعريف بالمغرب من منظور كولونيالي تمهيدا لاستعماره كباقي البلدان المغاربية، ومنها الجزائر تحديدا؛ ومن ثم فإن عمله، حسب هؤلاء، استخباراتيُّ، مهمته، في الدرجة الأولى، هي القيام بمهام استطلاعية واستعمارية عن ثقافة المغرب و لغاته وعاداته وسكانه وأنساقه السياسية والتاريخية. ورغم أهمية هذه الملاحظة فإن المتأمل الحصيف سيصل إلى نتيجة من المرجح لدينا أنها تنطبق على كُتاب ورحالة أجانب عديدين، وهي أن الرجل انخرط بالفعل، عن اعتقاد وإيمان علمي راسخ، في عملية ذهنية علمية فكرية محمومة أحلّها مكان الصدارة في انشغاله بالمغرب خاصة وشمال إفريقيا عامة محللا وملاحظا ومقارنا ومستنتجا؛ هذا علاوة على حرصه الشديد في تقصي الحقائق إلى حد يدفع القارئ إلى احترام المصداقية العلمية والمعرفية البتي يصدر عنها الرجل وهو يتناول العديد من القضايا الدينية والسياسية والثقافية التي طرقها في هذا الكتاب وفي كتاباته الأخرى، ومنها على الأخص كتابه الآنف الذكر”السحر والدين في شمال إفريقيا” وذلك بسبب تقارب منهج التناول بين الكتابين و كذا في الرؤية العامة التي وجهت مقصدية الباحث فيهما.
في هذا الكتاب نحن أمام رحالة يعرض الحقائق كما تبرز له ،يصفُها، يحللها، يقارن بينها وبين فضاءات متباينة (المغرب/الجزائر/تونس). من ثم اجتمع في الرجل مزيتان: دوتي الرحالة و دوتي العالم المشرَّب بالأفكار المهيمنة على الإثنوغرافيا المقارنة لعصره. هذا فضلا عن معرفة واسعة بالمصادر العربية القديمة التي وضعها نصب عينيه، معلقا، ومحللا، ومقارنا، بل ومصححا و،في أحايين كثيرة، مبرزا لوجهة نظره واجتهاده الخاص. هكذا نجد البكري وابن خلدون وغيرهم كممثلين للمدونة التاريخية الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع مؤرخين ورحالة كبار أجانب من أمثال موراليس ولا كروا ودوفوكو وشرينر وهاريس وترومليت وفون مالتزان [4]، هذا دون الحديث عن الروايات الشفوية المرتبطة بأولياء وصلحاء كُثر كان دوتي يستدل بها للتحقيق في أصول المقدس والأضرحة وانتشارها وزيارتها في المغرب وشمال إفريقيا.
يبدو إدموند دوتي واعيا بحدود عمله وبما تفرضه المقاربة الإنثربولوجية من مقارنات بيد أن المصادر الشفوية من خلال الأمثلة المأخوذة من المغرب تحديدا ركيزة أساسية للدراسة مع إيمان واعتراف أخير يظل بموجبه هذا البحث مجرد محاولة لا تدعي الشمولية ،وهو اعتراف يربط بين مقدمة الكتاب وبين خاتمته التي يدعو فيها إدموند دوتي إلى أن ظاهرة زيارة الأولياء والتبرك بالصلحاء ورسوخها في شمال إفريقيا عموما والمغرب بالخصوص ما يزال موضوعا بكرا يحتاج إلى إعادة قراءة واستئناف جديد. إن نقطة الإنطلاق عند دوتي عبارة عن فكرة أساسية مؤداها أن غياب الوسيط بين الله وبين المؤمن كان أهم باعث على ظهور التبرك بالأولياء والصلحاء. ذلك أن الناس الذين اعتنقوا الإسلام عن إيمان لم يستطيعوا الفكاك عن أهمية الوسيط في التقرب إلى الله زلفى، ولربما كانت سببا في تعزيز مفهوم الشفاعة والتعلق به ما دام وساطة يمثلها النبي بين الناس وبين الله.
يتعرض دوتي في هذا الكتاب إلى إشكالية الصلحاء محاولا الإحاطة بدورها الديني والسياسي والثقافي ،متتبعا لجدورها وامتداداتها في العديد من الممارسات الراهنة، مما يجعل عمله هذا أساسيا في الوقوف عند أحد أهم الملامح التي تكوّن فيها ومن خلالها المتخيل الجمعي المغربي (الدين والتصوف خاصة). فظاهرة الأولياء والتبرك تتجاوز كونها مجرد طقس إلى كونها ظاهرة مجتمعية تستحق أن تُدرس بمنهجية جديدة قادرة على استكناه البنيات العميقة (الدينية في الغالب) التي صنعت أهم الأحداث السياسية، بل وفسحت المجال لقيام دول على أساس ديني محض (المرابطون على سبيل المثال). من ثم كان لزاما على الباحث أن يتحدث عن موقع الصلحاء في الإسلام المغاربي عامة مبرزا أهم خصائصه ،ليدلف بنا إلى توزيعهم الجغرافي ،متتبعا، في الوقت نفسه، دلالة كلمة “المربوط” و”الرباط ” وكيف استقرت دلالة كلمة marabout في الممارسة اليومية من خلال طقوس الزيارة والتبرك. وتتبع الباحث التأثير المحلي الكبير الذي كان للصلحاء في حياة الناس ،ثم توقف مليا عند المدلول السياسي للكلمة من خلال بحث أصولها وعلاقتها بدولة المرابطين وحركتهم الإصلاحية، كما بحث في مدلول كلمات “مولايْ” و”لفْقيه” و”لاَلاَّ” و”دَادّا” و”الشْريفْ” وعلاقتها بالصلاح وتحدث عن علامات الصلاح وخصائصه، و عرض قبائل الصلحاء وسادتها مميزا بين صلحاء المدن وصلحاء القرى وعرج على سيدي عبد السلام بن مشيش كأحد أكبر الصلحاء الذين عرفهم تاريخ المغرب ثم عن الصلحاء المُزوّرين أو المدّعين للنسب الشريف، وصلحاء وقفوا إلى جانب المستعمر وطالبوه بالتدخل وآخرون ادعوا صحابة الرسول(ص)، وانبرى مميزا بين أنواع من الصلحاء فمنهم من ازدادوا صلحاء بالفطرة ومنهم من كان صالحا بالأعمال، وآخرون عُرفوا بالزهد والتقشف، وآخرون منهم اشتهروا بكونهم صلحاء حُمّاق، بينما رُوي عن بعضهم تعاطيهم لأنواع شتى من الفسق والفجور كالزنى والخمر وزواج آخرين بمسيحيات.
إن الشكر في الإطلاع على خبايا هذا الموضوع في لغة الضاد موصول، أولا وقبل كل شيء، للمترجم والباحث الجاد الدكتور محمد ناجي بن عمر . الذي بذل جهدا ليس باليسير في ترجمة هذا العمل، وشرّفنا مشكورا بمراجعته الكتاب وتقديمه إلى اللغة العربية. وقد بذلنا في ذلك ما استطعناه من جهد شاكرين له هذه الثقة وآملين أن يجد فيه القارئ بعض ما يشفي غليله المعرفي والثقافي والعلمي، متمنين للزميل المترجم مزيدا من التوفيق في ترجماته التي نعلم أنها لن تكون الأخيرة في التصدي إلى نقل هذه الأسفار من الكتب الكولونيالية بخاصة إلى اللسان العربي، والكتب الأجنبية المهتمة بحقبة أو حقب من التاريخ المغربي الحديث عامة.
من تقديم الدكتور حسن الطالب
[1] – لويس أرنو ، زمن المحلات السلطانية ..، ترجمة محمد ناجي بن عمر،منشورات إفريقيا الشرق،2001.
[2] – إدموند دوتي، مراكش: الشاوية ودكالة الرحامنة سنتي :1901-1902،ترجمة محمد ناجي بن عمر، وتقديم الدكتور محمد المازوني ، ط 1.مطبعة أنفو- برانت. 1431/2010.
[3] – إدموند دوتي ،السحر والدين في أفريقيا الشمالية، ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم، 2008.
[4] – انظر هوامش القسم الأول من الكتاب.
Auteur : ترجمة : محمد ناجي بن عمر
Date de publication : 2014
Langue : العربية
Nombre de Pages :
Editeur : منشورات افريقيا الشرق - الدار البيضاء